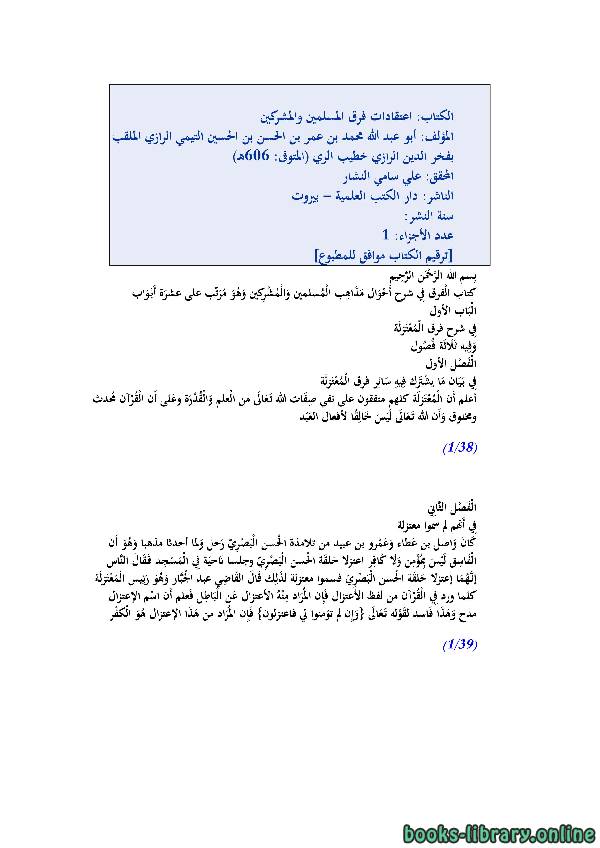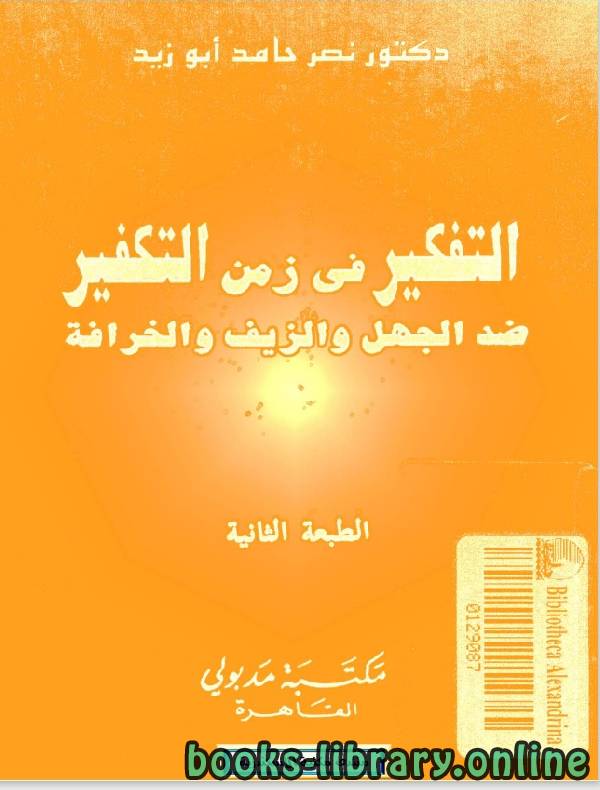كتاب التفكير اللاهوتي عند بول تيليش: لا يصدق المطلق إلا على الله
من يتناول فلسفة بول تيليش بالقراءة والفحص والنقد يكتشف ما تتسم به هذه الفلسفة من جرأة ورؤية نقدية عميقة لتفكيره الديني وتساؤلاته الروحية واللاهوتية. والبيِّن ـ كما سنرى ـ أن موقف الاستقلال الذي اتخذه على التخوم الفاصلة بين الفلسفة واللاّهوت مكّنه من مواجهة هذه المشكلات بكثير من الحرية. وسنلاحظ من خلال أعماله المتميزة كيف جرت مساعيه باتجاهات مختلفة: محاولة عصرنة اللاهوت، وإنهاء التبعية اللاهوتية للأفكار السائدة، واتخاذ موقف الاستقلال الفكري إزاء المناقشات اللاهوتية حول طبيعة المسيح، وإلى ذلك أيضاً، النقد التاريخي للكتاب المقدس، واللاهوت الدفاعي، ومشكلة الانفتاح، والنزعة الفائقة للطبيعة، ومفهوم الخلاص، وعلاقة اللاهوت بالتطور العلمي، ولغة الدين، والسلطة الكنسية الخ.. هذا إلى تأثّره ببعض الفلاسفة حيث نمّى لديه حسّاً نقديّاً، ورؤية معمّقة لأهم المشكلات الدينية واللاهوتية والحضارية في عصره. لا يمكن تصنيف بول تيليش (Paul Tillich 1886 -1965) ضمن فئة محدّدة من فئات اللاهوت المعروفة. هذا لا يعني إنكار أنه يدين بالكثير لشلايرماخر ولغيره من المفكّرين. فهو نفسه يعبّر عن أسفه لـ «الطريقة الرخيصة والخرقاء في تقسيم اللاهوتيين إلى طبيعيين naturalists وفوق طبيعيين supernaturalists أو ليبراليين وأرثودوكس». من هنا يمكن تحديد مجال واتجاه اهتمامات تيليش من خلال التركيز على أربعة موضوعات في كتاباته. أولاً، إنّ تيليش يفكّر ويكتب انطلاقاً من كونه متكلماً (مدافعاً ) مسيحيّاً Apologist. فهو يحاول أن يدرس المسيحية من الخارج كما يدرسها من الداخل، وهو بالتالي شديد الاهتمام بالأزمات الإنسانية في القرن العشرين. يقول: «إن معظم كتاباتي تحاول تحديد طريقة ارتباط المسيحية بالتراث العلماني». وقد عُرض أهم مؤلفات تيليش «اللاهوت النسقي» (Systematic Theology) ذي الثلاث مجلدات على شكل خمس مجموعات من الأسئلة والأجوبة صيغت بلغة دفاعية. يبدأ المجلّد الأوّل بنقاش مفصّل للمنهج، يليه أسئلة حول العقل الإنساني، وهذا يوحي بإجابات ترتبط بالوحي. يلي ذلك أسئلة حول «الوجود» اقتُرحت لها إجابات رمزية تشير إلى «الإله». في المجلّد الثاني أسئلة عن الوجود المادي ترتبط بأسئلة إضافية تتعلّق بالمسيح بوصفه الوجود الجديد. وأخيراً في المجلد الثالث، غوامض الحياة التي ترتبط بعقيدة الروح؛ وتساؤلات حول معنى التاريخ تجد إجابات لاهوتية في عقائد متعلقة بمملكة الله. ومن الركائز التي تقوم عليها أعمال تيليش أن «الدفاعيات وعلى الرغم مما يكتنفها من غموض تفترض وجود أرضية مشتركة». بناء على ذلك يعرّف تيليش اللاهوت الدفاعي بأنه لاهوت جوابي answering theology. حيث يقول: «باستخدام منهج التضايف، يستمرّ اللاهوت النسقي على الشكل التالي: إنه يحلّل الحالة الإنسانية التي تُثار منها الأسئلة الوجودية، ويبيّن أن الرموز المستعملة في الرسالة المسيحية تحمل أجوبة عن هذه الأسئلة» لكننا قد نخطئ، إذا تصوّرنا أن تيليش يفرط في العقلانيّة عندما يشخّص أسئلة الإنسان العلماني. ففي أكثر كتبه شعبية «الشجاعة في أن تكون» the courage to be مثلاً، يسبر غور القلق الإنساني حول المصير والموت، وتجربته في الخواء واللاَّمعنى، وفي شعوره بالذنب والإدانة[5]. فلتيليش علاقة مهمّة بالرومانسية، من موسيقى وعمارة وأدب، وبصورة خاصة الرسم الذي يحتل مكانة مهمة في حياته. من هنا لا يشكّل اللاهوت الدفاعي بالنسبة له، على الإطلاق، مسألة تفكير مجرّد. إنّه مهتم بمشاكل الحياة، وليس بالمشاكل الفكرية فحسب، حيث تمثّل مواقفه السياسية المتعاطفة مع الاشتراكية وجهاً من هذا الاهتمام المتعدّد الجوانب. ثانياً، تيليش مهتم بأن المطلق ينبغي أن يصدق على الله فقط. ويمكن التعبير بشكل أسهل عن هذه النقطة بالطريقة السالبة: لا يمكن إدّعاء الإطلاق أو اللاَّتناهي لأي حقيقة متناهية سواء أكانت شخصاً أو رمزاً أو حدثاً أو حتى كتابة مقدّسة. النعمة غير مقيّدة بأي شكل متناهٍ، سواء أكان كنيسة، أو كتاباً أو سرّاً مقدّساً. والقيمة الأكثر إيجابية لجميع هذه الصيغ الدينية تكمن فقط في إمكان إشارتها إلى المطلق الذي يتجاوز ذواتها. وهذا المبدأ كما سنرى، ينطبق حتى على الصيغ المفهومية الدالة على الله. فلا شيء سوى «الله» الذي هو فوق ووراء هذه الصيغ منزّه عن النقد والنسبوية من بين الموجودات المتناهية الأخرى. إن الاعتقاد بأن أي شيء في العالم، حتّى التعاليم والكتاب المقدّس والكنيسة، يجب أن يخضع للنقد، يسمّيه تيليش «المبدأ البروتستانتي»، ويجعله محوراً أساسياً في فكره اللاهوتي. فعلى الأقل، يلزم عن مبدإ الإصلاح البروتستانتي أن تكون البروتستانتية نفسها عرضة للمناقشة. هكذا يعلن تيليش «الحاجة لتحوّل ديني وثقافي بروتستانتي عميق واضح... فنهاية المرحلة البروتستانتية هي... ليست العودة إلى المسيحية الأولى، ولا هي خطوة نحو شكل جديد من العلمانية. إنها شيء يتجاوز جميع هذه الأشكال، شكل جديد من المسيحية، يجب توقّعه والتحضير له، لم تتم تسميته بعد». ثمّة عامل إضافي في إعداد تيليش لمبدإ البروتستانتية، هو حبّه المبكر للبحث الفلسفي. في كتابه Autobiographical Reflections يستذكر كيف ساهمت الفلسفة في مساعدته بمناقشاته اللاهوتية المبكرة مع والده، الذي كان قسّيساً لوثريّاً. فقد بدأ يشعر بضغط هائل جرّاء التحفّظ اللاَّهوتي لوالده الذي كان أيضاً يتبنّى الرؤية اللوثرية الكلاسيكية والتي تفيد بأن أي فلسفة أصيلة لا يمكن أن تتعارض مع الحقيقة النابعة من الوحي. يذكر تيليش المدّة الزمنية التي استنفذتها النقاشات الفلسفية بينهما، حتى «من موقع فلسفي مستقل انتشرت حالة الاستقلالية في جميع الاتجاهات». يصف هذه التجربة بأنها «خرق نحو الاستقلالية التي جعلتني محصّناً من أي نظام فكري أو حياة تطلب التنازل عن هذه الاستقلالية». ثالثاً، يرى تيليش أنه يؤدّي مهمة وسائطية. فهو يؤكّد على هذا الأمر بشدّة في سيرته الذاتية المطوّلة التي وضع لها عنواناً معبّراً «على الحدّ» on the boundary. إنه يتمنّى أن يقوم بدور الوسيط أو المترجم على الحدود بين اللاهوت والفلسفة، بين الدين والتراث، بين اللوثرية والاشتراكية، بين الحياة العقلية الألمانية ونظيرتها الأميركية وهلمّ جرّاً . يشن تيليش حرباً على الانقسام والتجزئة، فالتشظي والأخذ بالجزئيات وإهمال الكليات بالنسبة لتيليش يُرمز إليه مباشرة بالشيطاني فقط. غايته إذاً، رأب الصدع الذي يحجب الرؤية بطريقة تعيق النظر إلى الحياة والفكر ككل واحد. ويعتقد أن نقصان المعرفة وقلّة الاهتمام يضيّقان آفاقنا لنصل إلى المستوى الذي لا نرى فيه الكليات، بل نرى الأشياء أجزاء مستقلة ومجالات تخصصية. وهذا، بالنسبة لتيليش، يشرح على نحو جزئي، سبب فشل الإنسان الحديث في عصر التكنولوجيا والتخصص، في طرح أسئلة عن الوجود، أو عن الإله الذي يشكّل أساس كل الموجودات. رابعاً، يمكننا هنا أن نذكر بإيجاز، وكمقدمة لمناقشة لاحقة تتناول محاولات تيليش في أن يعدل بين ثلاث مجموعات من الأفكار التي يستلّها من المفكرين الذين أثّروا فيه. فمن جهة هو مدين جداً لسيكولوجيا يونغ Young، الذي كان لرأيه في الرموز واللاَّوعي أثر عميق في مقاربة تيليش للرموز الدينية. ومن جهة ثانية لا تختلف كليّاً، هو مدين بالكثير إلى نظرية شلايرماخر في التجربة الدينية[10]. يذكرنا كارل براتن Carl Braaten أن تيليش يتذكّر عندما كان شلايرماخر «مرفوضاً كصوفي»[11].وأخيراً، ومن جهة مختلفة كليّاً أخذ تيليش عن مارتن هايدغر ضروباً من التفكير أو الصور المفهومية التي يمكن استخدامها في اللاهوت. أو بدقة أكثر إنه يقبل اقتراح هيدغر أن اللغة حول «الوجود» أو «الإله» سوف تتعالى على مقولات الذات ـ الموضوع في التفكير المفهومي. وهذا يقدّم له مساعدة في محاولته تجنّب الخطاب المعرفي حول الله كبديل للغة الرمزية. عندما نضع هذه المجموعات الأربع معاً، لن نتفاجأ بتعبير بعضهم عن إعجابه بأعمال تيليش، ولا بأن يرى فيه آخرون عدوّاً للإنجيل. فهناك من اعتبر كتاباته لاهوتاً دفاعيّاً وسائطياً، مثلاً يصف ت. م. غرين T. M. Green تيليش بأنه «اللاهوتي الأكثر تنويراً في زماننا»؛ كما يسمّيه و. م. هارتن W. m. Horton الأمل الأكثر إشراقاً من أجل لاهوت للمصالحة المسكونية. من جهة أخرى، يبرز التفكير في المبدإ البروتستانتي، حيث يعلن كنث هاملتون Kenneth Hamilton أن الشيء الوحيد الذي لم يقصده تيليش مطلقاً هو أن «اللاهوت المسيحي» رسالة سلطوية يجب القبول بها» و«إن فهم نظام تيليش ككل يعني أن نعرف أنه متعارض مع الإنجيل المسيحي». ومن جديد لن نتفاجأ أن بعض الكتّاب «الروم ـ كاثوليك» سجّلوا الموقف التالي: يضعنا تيليش أمام السؤال التالي: إلى أي حدّ يمكننا توسعة آفاقنا اللاهوتية قبل أن يفقد لاهوتنا مسيحيّته؟ كم من المكوّنات يمكننا ضخَّها في الفكر الديني من قبل أن يصل إلى الانفجار تحت وطأة ضغط هذه المكوّنات؟ بالتأكيد لا ينبغي أن نختلف حول حقيقة أن تيليش كان مدركاً هذه الصعوبات، وأنه قصد تجنّبها. لكن مسألة النية تختلف عن مسألة النجاح.أنطوني تيسلتون - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التفكير اللاهوتي عند بول تيليش: لا يصدق المطلق إلا على الله ❝ الناشرين : ❞ مجلة الإستغراب ❝ ❱
من كتب دينية وفكرية الفكر والفلسفة - مكتبة المكتبة التجريبية.

قراءة كتاب التفكير اللاهوتي عند بول تيليش: لا يصدق المطلق إلا على الله أونلاين
معلومات عن كتاب التفكير اللاهوتي عند بول تيليش: لا يصدق المطلق إلا على الله:
وسنلاحظ من خلال أعماله المتميزة كيف جرت مساعيه باتجاهات مختلفة: محاولة عصرنة اللاهوت، وإنهاء التبعية اللاهوتية للأفكار السائدة، واتخاذ موقف الاستقلال الفكري إزاء المناقشات اللاهوتية حول طبيعة المسيح، وإلى ذلك أيضاً، النقد التاريخي للكتاب المقدس، واللاهوت الدفاعي، ومشكلة الانفتاح، والنزعة الفائقة للطبيعة، ومفهوم الخلاص، وعلاقة اللاهوت بالتطور العلمي، ولغة الدين، والسلطة الكنسية الخ.. هذا إلى تأثّره ببعض الفلاسفة حيث نمّى لديه حسّاً نقديّاً، ورؤية معمّقة لأهم المشكلات الدينية واللاهوتية والحضارية في عصره.
لا يمكن تصنيف بول تيليش (Paul Tillich 1886 -1965) ضمن فئة محدّدة من فئات اللاهوت المعروفة. هذا لا يعني إنكار أنه يدين بالكثير لشلايرماخر ولغيره من المفكّرين. فهو نفسه يعبّر عن أسفه لـ «الطريقة الرخيصة والخرقاء في تقسيم اللاهوتيين إلى طبيعيين naturalists وفوق طبيعيين supernaturalists أو ليبراليين وأرثودوكس». من هنا يمكن تحديد مجال واتجاه اهتمامات تيليش من خلال التركيز على أربعة موضوعات في كتاباته.
أولاً، إنّ تيليش يفكّر ويكتب انطلاقاً من كونه متكلماً (مدافعاً ) مسيحيّاً Apologist. فهو يحاول أن يدرس المسيحية من الخارج كما يدرسها من الداخل، وهو بالتالي شديد الاهتمام بالأزمات الإنسانية في القرن العشرين. يقول: «إن معظم كتاباتي تحاول تحديد طريقة ارتباط المسيحية بالتراث العلماني». وقد عُرض أهم مؤلفات تيليش «اللاهوت النسقي» (Systematic Theology) ذي الثلاث مجلدات على شكل خمس مجموعات من الأسئلة والأجوبة صيغت بلغة دفاعية. يبدأ المجلّد الأوّل بنقاش مفصّل للمنهج، يليه أسئلة حول العقل الإنساني، وهذا يوحي بإجابات ترتبط بالوحي.
يلي ذلك أسئلة حول «الوجود» اقتُرحت لها إجابات رمزية تشير إلى «الإله». في المجلّد الثاني أسئلة عن الوجود المادي ترتبط بأسئلة إضافية تتعلّق بالمسيح بوصفه الوجود الجديد. وأخيراً في المجلد الثالث، غوامض الحياة التي ترتبط بعقيدة الروح؛ وتساؤلات حول معنى التاريخ تجد إجابات لاهوتية في عقائد متعلقة بمملكة الله. ومن الركائز التي تقوم عليها أعمال تيليش أن «الدفاعيات وعلى الرغم مما يكتنفها من غموض تفترض وجود أرضية مشتركة».
بناء على ذلك يعرّف تيليش اللاهوت الدفاعي بأنه لاهوت جوابي answering theology. حيث يقول: «باستخدام منهج التضايف، يستمرّ اللاهوت النسقي على الشكل التالي: إنه يحلّل الحالة الإنسانية التي تُثار منها الأسئلة الوجودية، ويبيّن أن الرموز المستعملة في الرسالة المسيحية تحمل أجوبة عن هذه الأسئلة»
لكننا قد نخطئ، إذا تصوّرنا أن تيليش يفرط في العقلانيّة عندما يشخّص أسئلة الإنسان العلماني. ففي أكثر كتبه شعبية «الشجاعة في أن تكون» the courage to be مثلاً، يسبر غور القلق الإنساني حول المصير والموت، وتجربته في الخواء واللاَّمعنى، وفي شعوره بالذنب والإدانة[5]. فلتيليش علاقة مهمّة بالرومانسية، من موسيقى وعمارة وأدب، وبصورة خاصة الرسم الذي يحتل مكانة مهمة في حياته. من هنا لا يشكّل اللاهوت الدفاعي بالنسبة له، على الإطلاق، مسألة تفكير مجرّد. إنّه مهتم بمشاكل الحياة، وليس بالمشاكل الفكرية فحسب، حيث تمثّل مواقفه السياسية المتعاطفة مع الاشتراكية وجهاً من هذا الاهتمام المتعدّد الجوانب.
ثانياً، تيليش مهتم بأن المطلق ينبغي أن يصدق على الله فقط. ويمكن التعبير بشكل أسهل عن هذه النقطة بالطريقة السالبة: لا يمكن إدّعاء الإطلاق أو اللاَّتناهي لأي حقيقة متناهية سواء أكانت شخصاً أو رمزاً أو حدثاً أو حتى كتابة مقدّسة. النعمة غير مقيّدة بأي شكل متناهٍ، سواء أكان كنيسة، أو كتاباً أو سرّاً مقدّساً. والقيمة الأكثر إيجابية لجميع هذه الصيغ الدينية تكمن فقط في إمكان إشارتها إلى المطلق الذي يتجاوز ذواتها. وهذا المبدأ كما سنرى، ينطبق حتى على الصيغ المفهومية الدالة على الله. فلا شيء سوى «الله» الذي هو فوق ووراء هذه الصيغ منزّه عن النقد والنسبوية من بين الموجودات المتناهية الأخرى.
إن الاعتقاد بأن أي شيء في العالم، حتّى التعاليم والكتاب المقدّس والكنيسة، يجب أن يخضع للنقد، يسمّيه تيليش «المبدأ البروتستانتي»، ويجعله محوراً أساسياً في فكره اللاهوتي. فعلى الأقل، يلزم عن مبدإ الإصلاح البروتستانتي أن تكون البروتستانتية نفسها عرضة للمناقشة. هكذا يعلن تيليش «الحاجة لتحوّل ديني وثقافي بروتستانتي عميق واضح... فنهاية المرحلة البروتستانتية هي... ليست العودة إلى المسيحية الأولى، ولا هي خطوة نحو شكل جديد من العلمانية. إنها شيء يتجاوز جميع هذه الأشكال، شكل جديد من المسيحية، يجب توقّعه والتحضير له، لم تتم تسميته بعد».
ثمّة عامل إضافي في إعداد تيليش لمبدإ البروتستانتية، هو حبّه المبكر للبحث الفلسفي. في كتابه Autobiographical Reflections يستذكر كيف ساهمت الفلسفة في مساعدته بمناقشاته اللاهوتية المبكرة مع والده، الذي كان قسّيساً لوثريّاً. فقد بدأ يشعر بضغط هائل جرّاء التحفّظ اللاَّهوتي لوالده الذي كان أيضاً يتبنّى الرؤية اللوثرية الكلاسيكية والتي تفيد بأن أي فلسفة أصيلة لا يمكن أن تتعارض مع الحقيقة النابعة من الوحي. يذكر تيليش المدّة الزمنية التي استنفذتها النقاشات الفلسفية بينهما، حتى «من موقع فلسفي مستقل انتشرت حالة الاستقلالية في جميع الاتجاهات».
يصف هذه التجربة بأنها «خرق نحو الاستقلالية التي جعلتني محصّناً من أي نظام فكري أو حياة تطلب التنازل عن هذه الاستقلالية».
ثالثاً، يرى تيليش أنه يؤدّي مهمة وسائطية. فهو يؤكّد على هذا الأمر بشدّة في سيرته الذاتية المطوّلة التي وضع لها عنواناً معبّراً «على الحدّ» on the boundary. إنه يتمنّى أن يقوم بدور الوسيط أو المترجم على الحدود بين اللاهوت والفلسفة، بين الدين والتراث، بين اللوثرية والاشتراكية، بين الحياة العقلية الألمانية ونظيرتها الأميركية وهلمّ جرّاً .
يشن تيليش حرباً على الانقسام والتجزئة، فالتشظي والأخذ بالجزئيات وإهمال الكليات بالنسبة لتيليش يُرمز إليه مباشرة بالشيطاني فقط. غايته إذاً، رأب الصدع الذي يحجب الرؤية بطريقة تعيق النظر إلى الحياة والفكر ككل واحد. ويعتقد أن نقصان المعرفة وقلّة الاهتمام يضيّقان آفاقنا لنصل إلى المستوى الذي لا نرى فيه الكليات، بل نرى الأشياء أجزاء مستقلة ومجالات تخصصية. وهذا، بالنسبة لتيليش، يشرح على نحو جزئي، سبب فشل الإنسان الحديث في عصر التكنولوجيا والتخصص، في طرح أسئلة عن الوجود، أو عن الإله الذي يشكّل أساس كل الموجودات.
رابعاً، يمكننا هنا أن نذكر بإيجاز، وكمقدمة لمناقشة لاحقة تتناول محاولات تيليش في أن يعدل بين ثلاث مجموعات من الأفكار التي يستلّها من المفكرين الذين أثّروا فيه. فمن جهة هو مدين جداً لسيكولوجيا يونغ Young، الذي كان لرأيه في الرموز واللاَّوعي أثر عميق في مقاربة تيليش للرموز الدينية. ومن جهة ثانية لا تختلف كليّاً، هو مدين بالكثير إلى نظرية شلايرماخر في التجربة الدينية[10]. يذكرنا كارل براتن Carl Braaten أن تيليش يتذكّر عندما كان شلايرماخر «مرفوضاً كصوفي»[11].وأخيراً، ومن جهة مختلفة كليّاً أخذ تيليش عن مارتن هايدغر ضروباً من التفكير أو الصور المفهومية التي يمكن استخدامها في اللاهوت. أو بدقة أكثر إنه يقبل اقتراح هيدغر أن اللغة حول «الوجود» أو «الإله» سوف تتعالى على مقولات الذات ـ الموضوع في التفكير المفهومي. وهذا يقدّم له مساعدة في محاولته تجنّب الخطاب المعرفي حول الله كبديل للغة الرمزية.
عندما نضع هذه المجموعات الأربع معاً، لن نتفاجأ بتعبير بعضهم عن إعجابه بأعمال تيليش، ولا بأن يرى فيه آخرون عدوّاً للإنجيل. فهناك من اعتبر كتاباته لاهوتاً دفاعيّاً وسائطياً، مثلاً يصف ت. م. غرين T. M. Green تيليش بأنه «اللاهوتي الأكثر تنويراً في زماننا»؛ كما يسمّيه و. م. هارتن W. m. Horton الأمل الأكثر إشراقاً من أجل لاهوت للمصالحة المسكونية.
من جهة أخرى، يبرز التفكير في المبدإ البروتستانتي، حيث يعلن كنث هاملتون Kenneth Hamilton أن الشيء الوحيد الذي لم يقصده تيليش مطلقاً هو أن «اللاهوت المسيحي» رسالة سلطوية يجب القبول بها»
و«إن فهم نظام تيليش ككل يعني أن نعرف أنه متعارض مع الإنجيل المسيحي».
ومن جديد لن نتفاجأ أن بعض الكتّاب «الروم ـ كاثوليك» سجّلوا الموقف التالي: يضعنا تيليش أمام السؤال التالي: إلى أي حدّ يمكننا توسعة آفاقنا اللاهوتية قبل أن يفقد لاهوتنا مسيحيّته؟ كم من المكوّنات يمكننا ضخَّها في الفكر الديني من قبل أن يصل إلى الانفجار تحت وطأة ضغط هذه المكوّنات؟ بالتأكيد لا ينبغي أن نختلف حول حقيقة أن تيليش كان مدركاً هذه الصعوبات، وأنه قصد تجنّبها. لكن مسألة النية تختلف عن مسألة النجاح.
للكاتب/المؤلف : أنطوني تيسلتون .
دار النشر : مجلة الإستغراب .
سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
عدد مرات التحميل : 898 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الإثنين , 7 مارس 2022م.
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
من يتناول فلسفة بول تيليش بالقراءة والفحص والنقد يكتشف ما تتسم به هذه الفلسفة من جرأة ورؤية نقدية عميقة لتفكيره الديني وتساؤلاته الروحية واللاهوتية. والبيِّن ـ كما سنرى ـ أن موقف الاستقلال الذي اتخذه على التخوم الفاصلة بين الفلسفة واللاّهوت مكّنه من مواجهة هذه المشكلات بكثير من الحرية.
وسنلاحظ من خلال أعماله المتميزة كيف جرت مساعيه باتجاهات مختلفة: محاولة عصرنة اللاهوت، وإنهاء التبعية اللاهوتية للأفكار السائدة، واتخاذ موقف الاستقلال الفكري إزاء المناقشات اللاهوتية حول طبيعة المسيح، وإلى ذلك أيضاً، النقد التاريخي للكتاب المقدس، واللاهوت الدفاعي، ومشكلة الانفتاح، والنزعة الفائقة للطبيعة، ومفهوم الخلاص، وعلاقة اللاهوت بالتطور العلمي، ولغة الدين، والسلطة الكنسية الخ.. هذا إلى تأثّره ببعض الفلاسفة حيث نمّى لديه حسّاً نقديّاً، ورؤية معمّقة لأهم المشكلات الدينية واللاهوتية والحضارية في عصره.
لا يمكن تصنيف بول تيليش (Paul Tillich 1886 -1965) ضمن فئة محدّدة من فئات اللاهوت المعروفة. هذا لا يعني إنكار أنه يدين بالكثير لشلايرماخر ولغيره من المفكّرين. فهو نفسه يعبّر عن أسفه لـ «الطريقة الرخيصة والخرقاء في تقسيم اللاهوتيين إلى طبيعيين naturalists وفوق طبيعيين supernaturalists أو ليبراليين وأرثودوكس». من هنا يمكن تحديد مجال واتجاه اهتمامات تيليش من خلال التركيز على أربعة موضوعات في كتاباته.
أولاً، إنّ تيليش يفكّر ويكتب انطلاقاً من كونه متكلماً (مدافعاً ) مسيحيّاً Apologist. فهو يحاول أن يدرس المسيحية من الخارج كما يدرسها من الداخل، وهو بالتالي شديد الاهتمام بالأزمات الإنسانية في القرن العشرين. يقول: «إن معظم كتاباتي تحاول تحديد طريقة ارتباط المسيحية بالتراث العلماني». وقد عُرض أهم مؤلفات تيليش «اللاهوت النسقي» (Systematic Theology) ذي الثلاث مجلدات على شكل خمس مجموعات من الأسئلة والأجوبة صيغت بلغة دفاعية. يبدأ المجلّد الأوّل بنقاش مفصّل للمنهج، يليه أسئلة حول العقل الإنساني، وهذا يوحي بإجابات ترتبط بالوحي.
يلي ذلك أسئلة حول «الوجود» اقتُرحت لها إجابات رمزية تشير إلى «الإله». في المجلّد الثاني أسئلة عن الوجود المادي ترتبط بأسئلة إضافية تتعلّق بالمسيح بوصفه الوجود الجديد. وأخيراً في المجلد الثالث، غوامض الحياة التي ترتبط بعقيدة الروح؛ وتساؤلات حول معنى التاريخ تجد إجابات لاهوتية في عقائد متعلقة بمملكة الله. ومن الركائز التي تقوم عليها أعمال تيليش أن «الدفاعيات وعلى الرغم مما يكتنفها من غموض تفترض وجود أرضية مشتركة».
بناء على ذلك يعرّف تيليش اللاهوت الدفاعي بأنه لاهوت جوابي answering theology. حيث يقول: «باستخدام منهج التضايف، يستمرّ اللاهوت النسقي على الشكل التالي: إنه يحلّل الحالة الإنسانية التي تُثار منها الأسئلة الوجودية، ويبيّن أن الرموز المستعملة في الرسالة المسيحية تحمل أجوبة عن هذه الأسئلة»
لكننا قد نخطئ، إذا تصوّرنا أن تيليش يفرط في العقلانيّة عندما يشخّص أسئلة الإنسان العلماني. ففي أكثر كتبه شعبية «الشجاعة في أن تكون» the courage to be مثلاً، يسبر غور القلق الإنساني حول المصير والموت، وتجربته في الخواء واللاَّمعنى، وفي شعوره بالذنب والإدانة[5]. فلتيليش علاقة مهمّة بالرومانسية، من موسيقى وعمارة وأدب، وبصورة خاصة الرسم الذي يحتل مكانة مهمة في حياته. من هنا لا يشكّل اللاهوت الدفاعي بالنسبة له، على الإطلاق، مسألة تفكير مجرّد. إنّه مهتم بمشاكل الحياة، وليس بالمشاكل الفكرية فحسب، حيث تمثّل مواقفه السياسية المتعاطفة مع الاشتراكية وجهاً من هذا الاهتمام المتعدّد الجوانب.
ثانياً، تيليش مهتم بأن المطلق ينبغي أن يصدق على الله فقط. ويمكن التعبير بشكل أسهل عن هذه النقطة بالطريقة السالبة: لا يمكن إدّعاء الإطلاق أو اللاَّتناهي لأي حقيقة متناهية سواء أكانت شخصاً أو رمزاً أو حدثاً أو حتى كتابة مقدّسة. النعمة غير مقيّدة بأي شكل متناهٍ، سواء أكان كنيسة، أو كتاباً أو سرّاً مقدّساً. والقيمة الأكثر إيجابية لجميع هذه الصيغ الدينية تكمن فقط في إمكان إشارتها إلى المطلق الذي يتجاوز ذواتها. وهذا المبدأ كما سنرى، ينطبق حتى على الصيغ المفهومية الدالة على الله. فلا شيء سوى «الله» الذي هو فوق ووراء هذه الصيغ منزّه عن النقد والنسبوية من بين الموجودات المتناهية الأخرى.
إن الاعتقاد بأن أي شيء في العالم، حتّى التعاليم والكتاب المقدّس والكنيسة، يجب أن يخضع للنقد، يسمّيه تيليش «المبدأ البروتستانتي»، ويجعله محوراً أساسياً في فكره اللاهوتي. فعلى الأقل، يلزم عن مبدإ الإصلاح البروتستانتي أن تكون البروتستانتية نفسها عرضة للمناقشة. هكذا يعلن تيليش «الحاجة لتحوّل ديني وثقافي بروتستانتي عميق واضح... فنهاية المرحلة البروتستانتية هي... ليست العودة إلى المسيحية الأولى، ولا هي خطوة نحو شكل جديد من العلمانية. إنها شيء يتجاوز جميع هذه الأشكال، شكل جديد من المسيحية، يجب توقّعه والتحضير له، لم تتم تسميته بعد».
ثمّة عامل إضافي في إعداد تيليش لمبدإ البروتستانتية، هو حبّه المبكر للبحث الفلسفي. في كتابه Autobiographical Reflections يستذكر كيف ساهمت الفلسفة في مساعدته بمناقشاته اللاهوتية المبكرة مع والده، الذي كان قسّيساً لوثريّاً. فقد بدأ يشعر بضغط هائل جرّاء التحفّظ اللاَّهوتي لوالده الذي كان أيضاً يتبنّى الرؤية اللوثرية الكلاسيكية والتي تفيد بأن أي فلسفة أصيلة لا يمكن أن تتعارض مع الحقيقة النابعة من الوحي. يذكر تيليش المدّة الزمنية التي استنفذتها النقاشات الفلسفية بينهما، حتى «من موقع فلسفي مستقل انتشرت حالة الاستقلالية في جميع الاتجاهات».
يصف هذه التجربة بأنها «خرق نحو الاستقلالية التي جعلتني محصّناً من أي نظام فكري أو حياة تطلب التنازل عن هذه الاستقلالية».
ثالثاً، يرى تيليش أنه يؤدّي مهمة وسائطية. فهو يؤكّد على هذا الأمر بشدّة في سيرته الذاتية المطوّلة التي وضع لها عنواناً معبّراً «على الحدّ» on the boundary. إنه يتمنّى أن يقوم بدور الوسيط أو المترجم على الحدود بين اللاهوت والفلسفة، بين الدين والتراث، بين اللوثرية والاشتراكية، بين الحياة العقلية الألمانية ونظيرتها الأميركية وهلمّ جرّاً .
يشن تيليش حرباً على الانقسام والتجزئة، فالتشظي والأخذ بالجزئيات وإهمال الكليات بالنسبة لتيليش يُرمز إليه مباشرة بالشيطاني فقط. غايته إذاً، رأب الصدع الذي يحجب الرؤية بطريقة تعيق النظر إلى الحياة والفكر ككل واحد. ويعتقد أن نقصان المعرفة وقلّة الاهتمام يضيّقان آفاقنا لنصل إلى المستوى الذي لا نرى فيه الكليات، بل نرى الأشياء أجزاء مستقلة ومجالات تخصصية. وهذا، بالنسبة لتيليش، يشرح على نحو جزئي، سبب فشل الإنسان الحديث في عصر التكنولوجيا والتخصص، في طرح أسئلة عن الوجود، أو عن الإله الذي يشكّل أساس كل الموجودات.
رابعاً، يمكننا هنا أن نذكر بإيجاز، وكمقدمة لمناقشة لاحقة تتناول محاولات تيليش في أن يعدل بين ثلاث مجموعات من الأفكار التي يستلّها من المفكرين الذين أثّروا فيه. فمن جهة هو مدين جداً لسيكولوجيا يونغ Young، الذي كان لرأيه في الرموز واللاَّوعي أثر عميق في مقاربة تيليش للرموز الدينية. ومن جهة ثانية لا تختلف كليّاً، هو مدين بالكثير إلى نظرية شلايرماخر في التجربة الدينية[10]. يذكرنا كارل براتن Carl Braaten أن تيليش يتذكّر عندما كان شلايرماخر «مرفوضاً كصوفي»[11].وأخيراً، ومن جهة مختلفة كليّاً أخذ تيليش عن مارتن هايدغر ضروباً من التفكير أو الصور المفهومية التي يمكن استخدامها في اللاهوت. أو بدقة أكثر إنه يقبل اقتراح هيدغر أن اللغة حول «الوجود» أو «الإله» سوف تتعالى على مقولات الذات ـ الموضوع في التفكير المفهومي. وهذا يقدّم له مساعدة في محاولته تجنّب الخطاب المعرفي حول الله كبديل للغة الرمزية.
عندما نضع هذه المجموعات الأربع معاً، لن نتفاجأ بتعبير بعضهم عن إعجابه بأعمال تيليش، ولا بأن يرى فيه آخرون عدوّاً للإنجيل. فهناك من اعتبر كتاباته لاهوتاً دفاعيّاً وسائطياً، مثلاً يصف ت. م. غرين T. M. Green تيليش بأنه «اللاهوتي الأكثر تنويراً في زماننا»؛ كما يسمّيه و. م. هارتن W. m. Horton الأمل الأكثر إشراقاً من أجل لاهوت للمصالحة المسكونية.
من جهة أخرى، يبرز التفكير في المبدإ البروتستانتي، حيث يعلن كنث هاملتون Kenneth Hamilton أن الشيء الوحيد الذي لم يقصده تيليش مطلقاً هو أن «اللاهوت المسيحي» رسالة سلطوية يجب القبول بها»
و«إن فهم نظام تيليش ككل يعني أن نعرف أنه متعارض مع الإنجيل المسيحي».
ومن جديد لن نتفاجأ أن بعض الكتّاب «الروم ـ كاثوليك» سجّلوا الموقف التالي: يضعنا تيليش أمام السؤال التالي: إلى أي حدّ يمكننا توسعة آفاقنا اللاهوتية قبل أن يفقد لاهوتنا مسيحيّته؟ كم من المكوّنات يمكننا ضخَّها في الفكر الديني من قبل أن يصل إلى الانفجار تحت وطأة ضغط هذه المكوّنات؟ بالتأكيد لا ينبغي أن نختلف حول حقيقة أن تيليش كان مدركاً هذه الصعوبات، وأنه قصد تجنّبها. لكن مسألة النية تختلف عن مسألة النجاح.
اللاهوت الدفاعي ومشكلة الانفتاح
لقد أوجزنا في ما مرّ معنا، الخطوط العريضة لمنهج الأسئلة والأجوبة الدفاعية الذي اعتمده تيليش في كتاب اللاهوت النسقي Systematic Theology. والآن يجب أن ندرس بعض العقبات. يؤكّد تيليش بحرية أن لاختيار وصياغة أسئلته تأثيراً واضحاً على شكل ومضمون إجاباته[16]. فهو يصف علاقة السؤال-الجواب هذه بعلاقة التضايف. لكن بهذه الطريقة يثير شكّاً فوريّاً من جهتين. فمن جهة يعتقد كثير من اللاهوتيين أن أسئلة تيليش تحدّد إجاباته بشكل انتقائي وهذا ما يؤدّي إلى التحريف. ومن جهة أخرى، يعتقد عدد من الفلاسفة أن المعرفة المسبقة لإجاباته المفترضة تشحن الأسئلة وتوجّه صياغتها.
من خلال توقع هذه الانتقادات، يؤكّد تيليش أن محتويات إجاباته «لا يمكن أن تستمدّ من الأسئلة، أي من تحليل الوجود الإنساني. إنها «منطوقة» للوجود الإنساني من وراء هذا الوجود، وإلا لما كانت أجوبة»[17]. إنه يدعونا لاختبار دفاعياته عن طريق السؤال بانتظام، كما يفعل هو، «هل يمكن للرسالة المسيحية أن تتكيّف مع العقل الغربي من دون أن تفقد خاصيتها الأساسية والفريدة؟[18] يؤكّد أنه «من الضروري أن نسأل في كل مسألة خاصة ما إذا كان انحراف اللاهوت الدفاعي قد أضعف أم لم يضعف الرسالة المسيحية»[19]. لكن في الإجابة، علينا أن نقرّر أن تيليش، انطلاقاً من منهج التضايف، قد صاغ أسئلته بصيغة غير مرضية دائماً للاهوتيين أخرين على الرغم من أنه ينبغي تقدير كل مسألة جزئية بحسب أهليّتها.
لكن المشكلة من جهة الفلسفة مازالت أخطر. فعندما بدأ تيليش بكتابة «اللاهوت النسقي» Systematic Theology عام 1925، قصد التفكير بـ «الفيلسوف» كشخص شديد الاهتمام بنوع من المسائل والمناهج التي عالجها هايدغر في كتاب «الكينونة والزمن». لكننا رغم أن أشهر أعمال تيليش صدرت في مرحلته الأميركية الأخيرة، لا نملك دليلاً يشير إلى أنه غيّر جذريّاً تصوّره للفيلسوف الذي يخاطبه. فإذا قارنّا الفيلسوف في كتابات تيليش مع الفلاسفة الحاليين، سنزداد معرفة أن بعضهم فقط، وربّما قليل جدّاً منهم، قد يندرج في الفئة التي يقصدها تيليش. بالتأكيد هذا صحيح في بريطانيا وأميركا، حيث يندر وجود فلاسفة مثل هايدغر.
ربما كانت الحقيقة أن تيليش نتيجة للتناقص السريع في الاهتمام بالميتافيزيقا والأنطولوجيا، قد اضطر إلى اتخاذ مواقف فريدة. ففي كتاب «بواعث الإيمان» «Dynamics of faith» مثلاً، أعلن تيليش أن للفيلسوف «تصوراً مأزوماً للكون والإنسان»[20]. فالفلسفة بمعناها الحقيقي يمارسها أناس يتّحد في داخلهم عشق اهتمام مطلق مع ملاحظة جلية ومنفصلة لطريقة تجلّي الحقيقة المطلقة في صيرورات الكون[21]. لكن يبدو أن هذا التعريف للفلسفة لا يصف الموضوع كما يزاوَل عادة في التقليد الأنغلو ـ أميركي.
لو طُلب من الفيلسوف أو السائل أن يضمّ الجدية العاطفية إلى الانفتاح الفكري نحصل على لاهوتي. يقول تيليش: «كل لاهوتي ملتزم ومنعزل فهو دائماً في حالة إيمان وشك. إنه داخل الدائرة اللاهوتية وخارجها»[22]. لا يمكننا الشك في أن تيليش ينوي البقاء جزئيّاً داخل دائرة اللاهوت المسيحي. فمكانته في السياسة الألمانية ورفضه للهتلرية يدلّ على شيء واحد، أنه لا يمكن أبداً أن يتنازل عن منزلته اللاهوتية. ولكن هل يمكن، حقّاً، للاهوتي أن يعيش «في إيمان وشك» في الوقت نفسه؟ يجب الإعتراف بحقيقتين: أولاً، يمكن أن يكون للشك دور تطهيري وإيجابي في اللاهوت والدين من خلال فتح الأفق لإمكانية النقد الذاتي. لو لم يكن الشك موجوداً قط، لما كان بمقدور المرء أن يختبر ويمتحن أفكاره، ولما تسنّى له تطويرها. ثانياً، كل مدافع يقف خارج الدائرة اللاَّهوتية لا يمكن إلا أن يكون متعاطفاً ومؤيّداً. لكن تيليش لا يقول ببساطة «لو كنت خارج الدائرة اللاهوتية...». إنه في الواقع يتوقف هنا. غير أن هذا قد يحصل فقط من خلال إبدال فكرة الإيمان التقليدية بوصفها ثقة والتزام بمفهوم الإيمان المميّز عند تيليش كـ «اهتمام مطلق». في إحدى ندواته الحديثة أبدى ملاحظة حول الالتزام المسيحي: «للكلمة بالنسبة لي وقع سيّئ جداً. أنا لا أحبه... إننا لا نستطيع أن نلزم أنفسنا بشيء على نحو جازم»[23]. مثلاً، إن أيّ ميثاق أبدي «مستحيل، لأنه يعطي للحظة المتناهية التي نريد فيها فعل هذا الالتزام سموّاً مطلقاً على جميع اللحظات اللاحقة في حياتنا»[24]. فطلب الالتزام يعني التغافل عن «نسبية الدين الإنساني»[25].
الله والاهتمام المطلق
إن دون رغبة تيليش بإبدال هذين المفهومين صعوبات كثيرة، خصوصاً في ضوء إعلانه عدم التنازل عن أي جزء من أخبار الكتاب المقدّس»[26] مثلاً، إن لغة بولس الحاسمة حول موت وقيامة المسيح تفقد معناها لو أراد مسيحي الرجوع إلى وجهة نظره المذكورة سابقاً. في المقابل، لا ريب أن بإمكان تيليش أن يبيّن أن بولس بالنسبة لليهود أصبح كاليهود و«لأولئك الخارجين عن القانون أصبحت كواحد خارج القانون» (كورونتس الأولى 9:20-21) لكن بينما يبدو أمر التصدّي لتخلّي تيليش عن أهمية الالتزام مغرياً وربما ضروريّاً، إلا أن الأمر الأكثر إلحاحاً هو دراسة ما يقترحه كبديل، أي فكرة الاهتمام المطلق.
ترتبط فكرة الاهتمام المطلق عند تيليش بتصوره للإله، وباعتبارات أخرى تتعلّق باللاهوت الدفاعي. يمكن أن نعرّف بالموضوع من خلال توصيف وجهة نظر دفاعية قد يتعاطف معها حتى أكثر المفكرين تحفّظاً. يفترض تيليش أن الكافر يتصوّر، أحياناً، أنه رفض الله، فقط عندما يرفض صورة طفلية أو مفهوماً وضعه أحد اللاهوتيين. وهو بهذا يعتقد أنه حسم الجدل في مسألة «الله» بشكل نهائي. في حين أن كل ما حسمه هو موقفه من فكرة ما. وهكذا يدعو تيليش الباحث إلى إعادة فتح مسار بحثه على أساس أن فهم الحقيقة الإلهية أعمق من «إله» تعبّر عنه صورة مفهومية جزئية. «قد نكون قادرين على طرده من وعينا لمدة من الزمن... وعلى مناقشة عدم وجوده باقناع... لكن في النهاية سنعرف إنه ليس هو من رفضنا ونسينا، بل صورة مشوّهة عنه»[27]. ولكي يتخلّص تيليش من هذه الصور المشوّهة يحاول إعادة ترتيب بعض الرموز التقليدية المتعلقة بالله. إذاً، يمكن فقط من خلال استعمال مجموعة من الرموز الخلاقة بما يكفي، والمرنة و«غير المطلقة» اجتناب الخلط بين «الله» وغيره من «الآلهة».
غير أن الحجّة نفسها يمكن أن تُقلب رأساً على عقب، وتنطبق بالمستوى نفسه والتأثير على موقف المؤمن. وبالضبط كما نستطيع دفع غير المؤمن إلى رفض مجرّد رمز، كذلك نستطيع دفع المؤمن إلى قبول مجرّد رمز، بوضع الرمز مكان الله. فكلّما وجد الرمز مزيداً من القبول، كّلما ازداد المأزق حرَجاً. فمجرّد الرضا بالرمز الديني، لا يضمن بالضرورة صدقاً يصل إلى مستوى يتجاوز الحالة النفسية. إن تيليش مدرك تماماً لهذا الخطر، لذلك يصفه بالوثنية من دون أية مراعاة. ويعلن بصراحة أن «الإله الذي يمكننا تحمّله بسهولة، والإله الذي لا نضطر إلى إخفائه، والإله الذي لا نكرهه في بعض اللحظات... ليس إلهاً البتّة»[28].
بالتأكيد تيليش ليس فريداً في عرض هذه المسألة[29]. لكن الإجابة التي يقدمها تنطوي على إعادة تعريف اللاهوت بصورة جذرية. فعنوان أحد كتبه «زعزعة الأسس» the shaking of the foundations يعبّر عن وجهة نظر المؤمن، وهذا بالضبط ما يريده تيليش. إنه يرغب أن يصدمه بتقدير الموقف من زاوية مختلفة تماماً. يؤكّد تيليش أن سؤال ما هي العقيدة التي على المرء الإيمان بها؟ أو أي دين عليه أن يعتنق؟ لن يحلّ المشكلة؛ لأن أي إنسان يمكن أن يفكر في أسباب تؤدّي إلى اعتناق عقيدة جذّابة بما يكفي. فما يهمّ وما ينبغي أخذه بالحسبان هو موقف المرء تجاه ما يؤمن به. فلا يمكن تجنّب الوثنية إلا إذا كان هذا الموقف هو «اهتمام مطلق». إذا عبّر هذا عن وجهة نظره يكون كل شيء في موضعه. إذ مهما كان مضمون إيمانه النوعي، فإذا كان يوصل إلى اهتمام مطلق. فهو يًشكل رموزاً صالحة توصله إلى الله الذي يسمو على أي إله.
يشكّل «الاهتمام المطلق» مصطلحاً تقنيّاً في مفردات تيليش. يعمل أحياناً أكثر من مجرد مرادف للإيمان. فهو يقول: «الإيمان هو حالة من الاهتمام المطلق؛ فديناميات الإيمان هي ديناميات الاهتمام المطلق للإنسان»[30]. لكن الإيمان يعني، أيضاً، أكثر من ذلك. يؤكّد تيليش أنه يشير إلى الموقف الإيماني للإنسان وإلى موضوع الإيمان المقدّس معاً، فهو يعتقد أنّ «فعل الإيمان المطلق والمطلق في فعل الايمان متطابقان ومتّحدان»[31].
تمسّك ناقدو تيليش، وبشيء من الإنصاف، بهذه العبارة كنموذج متعمّد للغموض الذي صاغه تيليش ليستخدمه في دعم مواقفه اللاهوتية. فإذا رغب أحد بالدفاع عنه أو بفهمه بطريقة فيها تعاطف، قد لا يستطيع شرح العبارة إلا بشكل مخالف لخلفية تصوّر تيليش للمقدّس وللعلاقة بتجارب تيليش الأولى. فهو يستذكر في سيرته الذاتية «autobiographical Reflections» الكنيسة القوطية Gothic church الجميلة التي شغل فيها والده موقع أحد الآباء الناجحين، كما يتذكر الأشخاص والمدرسة التابعة للكنيسة. كما أنه يشرح كيف منحته هذه البيئة شعوراً بالقدسية، تجربة يصفها في ما بعد بأنها لا تقل عن كونها «أساس كل أعمالي الدينية واللاهوتية». ثم يتابع «عندما قرأت للمرة الأولى كتاب «فكرة القدسي» The Idea of the Holy لرودولف أوتو Rudolf Otto فهمته مباشرة على ضوء تلك التجارب القديمة... حدّدتُ منهجي في فلسفة الدين، حيث بدأت باختبارات للقدسي ثم ارتقيت إلى فكرة الله، لا بالطريقة المعكوسة»[32].
كل ما مر يساعدنا في أن نفهم لماذا عرّف تيليش الاهتمام المطلق بغموض متعمّد. فهو يتبنّى نفس مواقف أوتو وشلاير ماخر الدينية نفسها. يتطلّب وصف أوتو للقدسي وصفاً للمواقف والمشاعر الإنسانية تجاه القدسي. لكن أوتو يؤكّد أن هذه المواقف تشير إلى شيء يتجاوز الإنسان ذاته. هنا يعترض تيليش، ففي هذه النقطة بالتحديد تمّت إساءة فهم شلايرماخر بشكل كبير»[33]. إن تصوره لـ «للشعور» في الدين لم يكن قط «مجرّد» شعور، بل كان شعورًا موجّهًا إلهيّاً، إنه شعور بالمطلق. كما أن هايدغر يعالج الموضوع نفسَه. فقط لأن المشاعر أصبحت تُرى كـ «مجرّد» مشاعر، وجد نفسه مكرهاً على صياغة مصطلحات مثل «الحالة الشعورية» أو «القلق الوجودي». إذاً، تيليش ليس فريداً بإصراره على عدم إمكان تجنّب هذا الغموض، لكن هذا يضعه قطعاً في صفّ أوتو وشلايرماخر.
وهذا لا بدّ أن يثير مشاكل هائلة تتعلق بمحاولة التمييز بين التصوّر «الصحيح» لله والتصورات الخاطئة. على الأقل هذا ما يحصل من وجهة نظر الأرثوذوكس أو التقليديين. إذ لم يعد لدينا معيار لاهوتي يتعلّق بالمضمون المعرفي العقلي. لكن الله موجود مهما كان موضوع الاهتمام المطلق؛ إنه موجود مهما كان مصدر اختبار القدسي. هنا يكتب تيليش: «الله هو الاسم الذي لأجله يهتم الإنسان على نحو مطلق. هذا لا يعني أن هناك أولاً موجوداً يُدْعى «الله» ثم يطلب من الإنسان أن يهتم به اهتماما مطلقاً. بل يعني أن أي أمر يهمّ الإنسان على نحو مطلق يصير إلهاً بالنسبة إليه»[34]. لكن رغم ما في هذا الرأي من مشاكل من وجهة نظر أرثوذوكسية، إلا أنه ينسجم كليّاً مع نظام تيليش اللاَّهوتي. لا حاجة لأن نعتبر أن مفردات الاه تيليش مدين كثيراً لعلم النفس اليونغيpsychology of Jung. يعتقد يونغ أن الإنسان الحديث يعاني من شحّ الرموز. فإن جزءاً من مرض واضطراب الوعي الحديث ينبعث من فساد الصور والرموز التي كان لها في الماضي قوة حيوية. يبيّن يونغ أن النتيجة النهائية لهذا الاتجاه، سوف تكون شللاً وتعطّلاً؛ لأن الرموز حيوية من أجل التفاعل الضروري بين الوعي واللاوعي. هكذا يؤكّد تيليش، تماشياً مع يونغ، أن السر المقدّس، بخلاف الكلمة المجرّدة، إذا كان حيّاً، يستحوذ على لاوعينا وعلى وجودنا الواعي. فهو يستحوذ على الأساس الخلاق لوجودنا»[66]. وبما أن الله أيضاً بالنسبة لتيليش، أساس لوجودنا، نستطيع القول أنّ الرمز الذي يتغلغل إلى لاوعينا يدل على الله. عندما تُوضَع هاتان المجموعتان من الاعتبارات جانباً لن يكون مفاجئاً عندما يؤكّد تيليش أن «مرتكز عقيدتي اللاهوتية في العلم هو مفهوم الرمز»[67]. «الرموز الدينية... هي الطريقة الوحيدة التي يعبّر الدين من خلالها عن نفسه مباشرة»[68].
يقدّم تيليش عدداً من التقريرات المتشابهة عن الرموز، في كل واحد منها يضع نفس الخمس أو الست خصائص نفسِها للرموز في قائمة. أولاً، الرمز وكأيّ علامة عادية يمثل شيئاً مغايراً، ومن هنا فهو يشير إلى ما وراء ذاته. لكن ثانياً، الرمز يختلف عن العلامات التقليدية، لأنها يُفترض أن «تشارك في ما تشير إليه»[69]. وبمحاولة لشرح هذه الفكرة الغامضة يبيّن تيليش من خلال تشبيهٍ كيف أن العَلَم «يشارك في» كرامة الأمة. (ربّما علينا التفكير هنا بصورة خاصة في مكانة العلم في الحياة الأميركية.) وهذا بدوره يوحي بميزة ثالثة، يصفها تيليش بـ «الوظيفة الأساسية للرمز، أي فتح مستويات الواقع التي تكون مخفيّة والتي لا يمكن إدراكها بأي طريقة أخرى»[70].
بالنظر إلى تأثير الرموز على لغة الدين علينا أن نفحص عن قرب ما يؤثّر في هذه المسألة. يضرب تيليش مثلاً من المجال الفني، عندما يعلّق على منظر طبيعيّ لروبنز Rubens: «ما يحاول هذا الرسم إيصاله لك لا يمكن التعبير عنه بأي طريقة أخرى غير الرسم»[71]. ثم يتابع، «الأمر نفسه يصحّ أيضاً في علاقة الشعر بالفلسفة. قد يكون الجمال غالباً في التشويش على المسألة من خلال إقحام عدد كبير من المفاهيم الفلسفية في القصيدة. والآن المشكلة الحقيقية هي؛ أن المرء لا يستطيع فعل ذلك. فإذا استعمل اللغة الفلسفية أو اللغة العلمية، فإن هذه اللغة لا تستطيع التوسط في إيصال الأمرَ نفسَه الذي تتوسط في إيصاله لغة الشعر من دون مزجها بأي لغة أخرى»[72].
في هذه الحالة، ماذا يمكن أن نقول عن إنسان لا يكترث للمواضيع الجمالية؟ يجيب تيليش، بتحديد ميزة خامسة للرموز. وكما أشرنا سابقاً فإنّ الرمز يتغلغل عميقاً في اللاوعي. إذا كان الرمز صحيحاً للإنسانِ المعنِيِّ، فهو يستطيع أن يحدث فعل الدلالة التي يقتضيها. وهكذا يؤكّد تيليش «لكل رمز حدّان: الانفتاح على الواقع، والانفتاح على الروح»[73]. «إنه يستكشف الأعماق المخفية لوجودنا»[74]. وعلى هذا الأساس «لكل رمز وظيفة خاصة وحصرية ولا يمكن إبدالها برموز أكثر أو أقل مناسبة»[75]. كما يمكن أن تكون الرموز مرعبة بقدرتها. فهي تستطيع أن تخلق أو تدمّر، وتستطيع تضميد الجروح وتوحيد الحياة وجعلها أكثر استقراراً. لكنها تستطيع أيضاً إفساد الحياة وزعزعة استقرارها.
تتعلّق علامتا الرمز الخامسة والسادسة بولادته واحتمال اضمحلاله. ينجذب تيليش بشدة إلى علم النفس الحديث، خاصة كما قلنا سابقاً، إلى أعمال يونغ. فهو يعتقد أن الرموز «تنمو في اللاَّوعي الفردي أو الجمعي، ولا يمكن أن تؤدّي وظيفتها من غير أن تكون مقبولة من البعد اللاواعي لوجودنا... إنها كالموجودات الحيّة، تحيا وتموت»[76]. وهذا ينطبق على الرموز الدينية: «الرموز الدينية تنفتح على تجربة العمق في نفس الإنسان. إذا توقّف رمز ديني عن أداء وظيفته، فإنه يموت»[77]. وهكذا بالعادة، تتطلّب العلاقة المتغيرة مع الله رموزاً دينية جديدة. وقد يكون البديل أن يكون التغيير مطلب وجهات نظر ثقافية جديدة، وكمثال على ذلك، عندما يكون لـ «ملك» دلالة غير مرغوبة في جمهورية متطرفة.
سنجد صعوبات كبيرة في نظرية الرموز عند تيليش إذا تمّ تبنّيها كنظرية شاملة للغة تتعلّق بالله. لا أحد يشكّ في قدرة الرموز، أو قيمتها كوسيلة لغوية مكمِّلة تساعد في إيصال ما يمكن إيصاله بطريقة مختلفة عن الخطاب المعرفي. لكن تيليش يرى في الرموز ركيزة لفكره اللاهوتي. فلاهوته يدعم ويرسّخ
 مهلاً !
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'

نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:


كتب اخرى في كتب دينية وفكرية
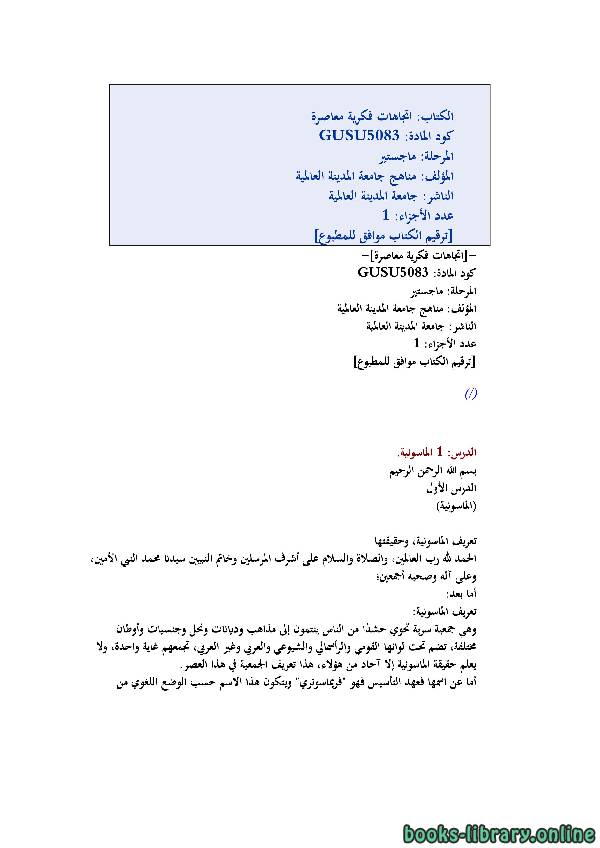
اتجاهات فكرية معاصرة جامعة المدينة PDF
قراءة و تحميل كتاب اتجاهات فكرية معاصرة جامعة المدينة PDF مجانا
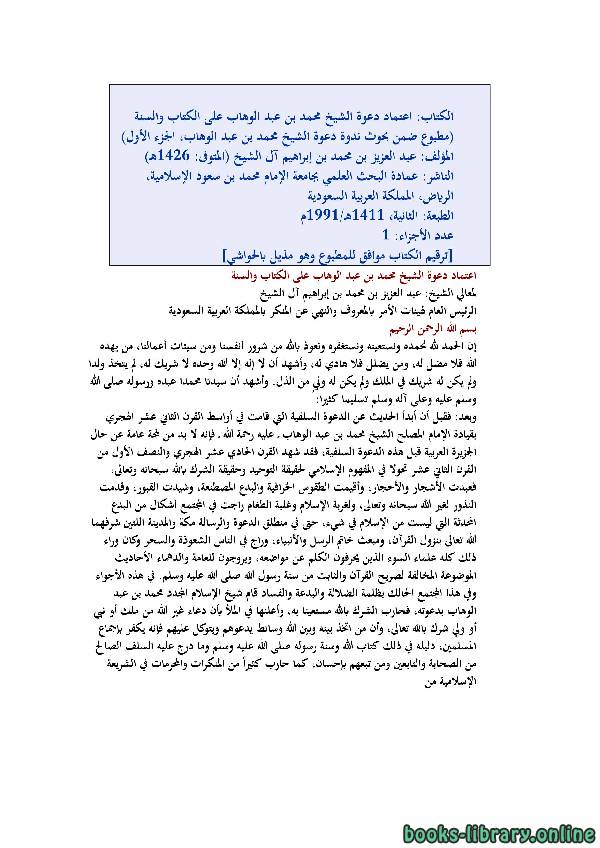
اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة PDF
قراءة و تحميل كتاب اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة PDF مجانا
The War on Terror State Crime Radicalization PDF
قراءة و تحميل كتاب The War on Terror State Crime Radicalization PDF مجانا
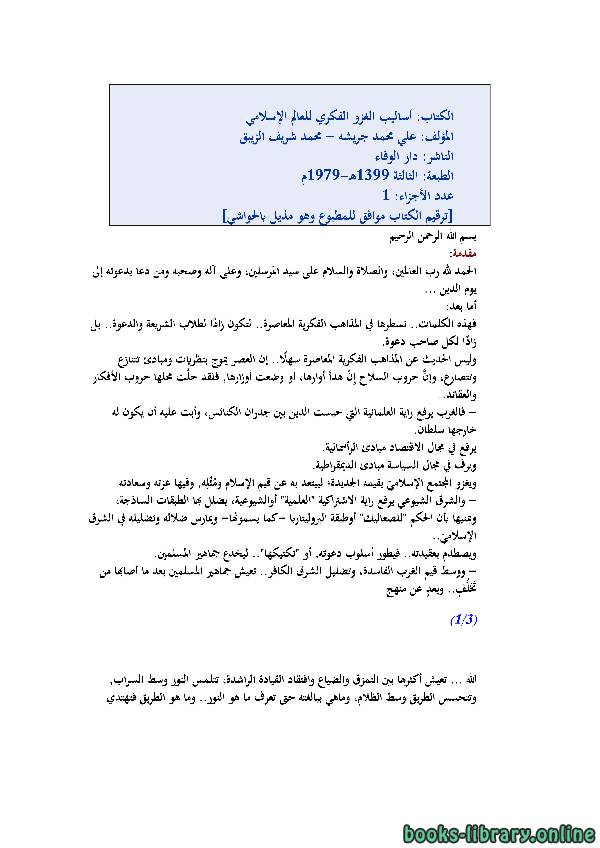
أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي PDF
قراءة و تحميل كتاب أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي PDF مجانا
المنبر في الشعائر الدينية للإسلام الأولي PDF
قراءة و تحميل كتاب المنبر في الشعائر الدينية للإسلام الأولي PDF مجانا